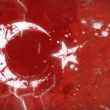يخطئ من يظن أن التاريخ كتلة جامدة وثابتة من أحداث دارت في مرحلة زمنية ما ثم
انتهت، ذلك أننا نتكلم أولاً عن التاريخ المكتوب، ثم عن فهمنا لهذا التاريخ المكتوب، وبالتالي فما نطلق عليه نحن اسم “التاريخ” يمر قبل وصوله إلينا عبر مرحلتين تؤثران في صياغته:
الأولى، كتابة التاريخ، فليس كل التاريخ كتب، وما حالفه الحظ منه بالتدوين كتبه المنتصرون، وفق روايتهم وما يوافق مصالحهم.
الثانية، ما قرأناه نحن من التاريخ، وما فهمناه أو أردنا أن نفهمه منه. وهناك مرحلة تالية على هاتين، هي مرحلة الاستفادة من التاريخ، سنتحدث عنها لاحقاً.
هكذا، نستطيع أن نقرر أن مقولة تأثير التاريخ فينا غير دقيقة، لأننا – في كثير من الأحيان – نؤثر في التاريخ، أو ما نسميه نحن “التاريخ”، من خلال العاملين السابقين.
ولذلك كانت الحالة النفسية التي تعيشها أمة من الأمم تحت ضغط الواقع الذي تعيشه عاملاً محدداً في طريقة تناول التاريخ ودروسه. ففي الدول والمجتمعات التي تسير على هدى التخطيط يسود “التاريخ الإيجابي”، أي عرض التاريخ بطريقة إيجابية محفزة للجماهير، بينما ينتشر في مجتمعات أخرى “التاريخ السلبي” وهو التناول الخاطئ أو المضطرب للتاريخ، مما ينتج حالة نفسية سيئة ومحبطة.
هذا التأثير للحالة النفسية المنعكسة من الواقع السياسي والاجتماعي على فهم التاريخ وتطبيقه قد يفسر لنا لماذا يعتبر شبابنا – في العصر الذي نعيشه – عمر بن الخطاب قدوة لهم وليس أبو بكر، أو لماذا يحبون خالد بن الوليد أحياناً أكثر منه، رغم إجماع الأمة على أفضليته عليهما وعلى جميع الصحابة، أو لماذا يعرفون عن سيرة صلاح الدين أكثر مما يعرفون عن حياة عمر بن عبد العزيز، وهو الخليفة الراشد الخامس وفق تقدير العديد من العلماء والمؤرخين، أو لم يبحثون في سيرة محمد الثاني “الفاتح” أكثر من تاريخ سليمان “القانوني”.
هكذا، نستطيع أن نتفهم أن أمة واقعها الهزيمة – النفسية قبل العسكرية – والتخلف واجتماع باقي الأمم عليها، ستسحضر من تاريخها الأحداث والشخصيات الممثلة لقوتها السياسية وانتصاراتها العسكرية، لا العاكسة مثلاً لقوتها العلمية أو تسامحها الأخلاقي أو نهضتها العمرانية.
بينما، في مشهد آخر، سنرى أن “نجوم” وقدوات العصور السابقة التي شهدت النهضة العلمية والقوة العسكرية والفتوحات لم يكونوا بالضرورة قادة الجيوش أو الامراء والخلفاء، بل رجال العلم والأئمة وأمثالهم.
تبدو هذه النظرة مهمة جداً في فهم الأبعاد النفسية للشعوب وما يترتب عليها من مواقف أو انحيازات قد تبدو – وفق التقييم الظاهري – غير مفهومة أو متناقضة. ذلك أن تأييد قطاعات عريضة من المصريين للمشير عبدالفتاح السيسي في انقلابه يرجع إلى فكرة “القوة” التي مثلها بالنسبة لهم. كما يصب تأييد قطاعات واسعة من الشباب العربي “لتنظيم الدولة” (أو داعش)، رغم غلوها الفكري ومواقفها الحادة وجرائمها المتواترة، في نفس الاتجاه. ورغم أن هذين الموقفين يبدوان – في الظاهر – متناقضين، إلا أنهما في صلبهما يصدران عن نفسية واحدة، تقدس مفهوم القوة، بغض النظر عن الحق والصواب والمنهج.
أكثر من ذلك، يبدو انبهار الكثيرين بشخصية “أبي عبيدة” الناطق الرسمي باسم كتائب القسام في الحرب الأخيرة على قطاع غزة طاغياً على أي إعجاب بأي قائد سياسي آخر، رغم أن دور الأول إعلامي – كلامي، بينما ربما يكون الثاني قائداً مقرراً للسياسات الناجحة للمقاومة، إلا أن انتماء الأول للذراع “العسكري” يعطيه تقدماً في وعي الشعوب وعقلها الباطن على “السياسي”، بغض النظر عن الدور والأداء في أحيان كثيرة.
وبالتالي، وعوداً على بدء، يصعب أن نطلق على ما بين أيدينا من كتب ونصوص وما نتداوله من قصص وحكايا مصطلح “تاريخ”، بل هي ما نعرفه – وفي تحديد أكثر ما “نريده” أو “نأمله” – نحن من التاريخ. ذلك أن تناولنا للأحداث التاريخية تشوبه ثلاثة عيوب مهمة ومؤثرة وخطيرة:
أولها، التناول الانتقائي للتاريخ، بأن نتداول او نتدارس حقبات معينة وأحداثاً محددة وشخصيات بعينها من التاريخ، ونهمل ما دونها، وهذا يعطي صورة حالمة أحياناً، وقاتمة أحياناً أخرى، ليست بالتأكيد الصورة المتكاملة للتاريخ.
ثانيها، طريقة تحليلنا لهذه الأحداث التاريخية ومنهجية استخلاص الدروس والعبر منها، ذلك أن منهجية الدراسة العلمية والتقييم الشامل بعيدة عن كثير من المشتغلين بالتاريخ أو المهتمين به، فنجد الدراسات الفردية أو المجتزأة أو السطحية، أو غيرها من المدارس غير القويمة لتناول التاريخ.
وثالثها وأخطرها، منهجية الاستدلال وإسقاط التاريخ على واقعنا، إذ يلوي الكثير منا أعناق النصوص التاريخية والأحداث السابقة ليؤكد بها وجهة نظره وأيديولوجيته، حتى ولو تناقض بعض ما يقول مع بعضه الآخر. ولأن النصوص حمالة أوجه فإن من يعتمد هذا النهج سيجد دائماً ما يسانده من أحداث أو مواقف أو أقوال، لكنها ستبقى بعيدة جداً عن الحقيقة والتاريخ والاستفادة وفهم الواقع وصياغة المستقبل.
إن أكثر ما نحتاج هو الدراسة العلمية الشاملة الوافية والدقيقة للتاريخ، تلك التي تبسطه لنا كما هو لا كما نأمل نحن أن يكون، ثم تستخلص لنا دروسه – وفق ظروفه وسياقاته – وتحاول مساعدتنا على الاستفادة من هذه الدروس في فهم الواقع ورسم المستقبل.
بيد أن دروس التاريخ واستخلاصاته مجرد جزء بسيط جداً من مفاتيح الفهم والحل، وليست كل شيء، وإلا حبسنا أنفسها في سراديب الماضي وتخلينا – كأحياء فاعلين – عن أداء دورنا وتصورنا الكفاية في السابقين، وهذا أبعد ما يكون عن المنطق والعقل.