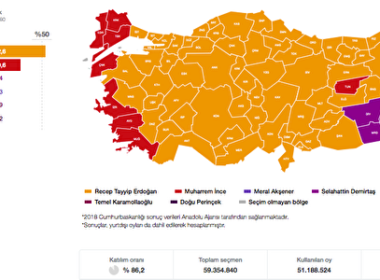ما زال اردوغان قادراً على شغل الرأي العام والصحافة في بلده وخارجها بشكل شبه يومي من خلال مواقفه أو تصريحاته أو أفعاله. ورغم أن الكثير من النقد الموجه للرجل منشؤه خلافات سياسية واستقطابات أيديولوجية على خلفية مواقفه ومواقف تركيا من قضايا المنطقة (مصر وسوريا تحديداً)، إلا أن مواقفه وتصريحاته نفسها تحمل الكثير من جينات الجدل، من حيث بعدها عن النمطية وخروجها عن النسق، أو من حيث هي تفصيلات يراها الكثيرون على هامش الفعل السياسي، وربما “لا تليق” برئيس الجمهورية أو بتركيا كدولة من وجهة نظر البعض.
يبدو هذا الكلام مكرراً جداً ومستهلكاً بين يدي الحديث عن كل موقف يشعل بعض “الجبهات” الإعلامية ضد الرجل، لكن تسارع هذه الأحداث وتكاثرها في الفترة الأخيرة، سيما بعد مشهد استقبال الرئيس الفلسطيني عباس بـ 16 جندياً يرتدون أزياء تاريخية مختلفة، يغري بمحاولة الغوص إلى أعمق من الحدث اليومي للبحث عن خلفية المشهد وسياقاته.
أتاتورك ومبادئ الجمهورية
بيد أن الحديث عن هذه الأحداث سيكون سطحياً جداً وغير ذي نفع إن لم تصحبه عودة سريعة – ولكن وافية – لجذور تأسيس الجمهورية التركية، وما أحدثه بانيها مصطفى كمال من تغيرات في بنية المجتمع وتوجهات الدولة. إن أوجز ما يمكن أن يوصف ما قام به الرجل ومن تبعه على نفس الدرب هو ثورة ثقافية وحضارية (بغض النظر عن تقييم ذلك إيجاباً أو سلباً) أرادت بتر الشعب التركي عن ماضيه بشكل كامل ونهائي لا رجعة فيه.
فقد ألغيت الأبجدية العربية وحلت مكانها الحروف اللاتينية، واستبدلت اللغة التركية باللغة العثمانية، ومنع الأذان بالعربية، وحظرت بعض الأزياء والألبسة (مثل الطربوش)، واستقدمت الأنظمة الأوروبية في التعليم والإعلام والتقاضي. وهي التغييرات التي اعتبرها المفكر الغربي صمويل هنتنغتون في كتابه صدام الحضارات “تغريباً” لا تحديثاً، أدى إلى نمط ثقافي – حضاري للدولة معاكس تماماً لإرادة الشعب، وهو ما جعل تركيا من وجهة نظره مثالاً على “الدولة الممزَّقة”، التي لا أمل بنجاحها أو نهضتها.
مع العدالة والتنمية
لكن بناء الجمهورية التركية على هذه المبادئ، التي أوكلت مهمة حمايتها للمحكمة الدستورية والجيش التركي (قام بأربعة انقلابات عسكرية) إضافة إلى عشرات السنوات من العمل الممنهج لترسيخها في الإعلام والتعليم وكافة مؤسسات الدولة، لم يكن أمراً يمكن تخطيه أو عكسه بسهولة، حتى مع أكثر الحكومات شعبية وإنجازاً. فمجرد محاولات الاقتراب من هذه الخطوط الحمراء أفشلت عدة حكومات وحظرت عدداً من الأحزاب وأوصلت أحد رؤساء الحكومة إلى منصة الإعدام.
ولذلك، فلم يكن من أولويات العدالة والتنمية حين تسلم مقاليد الحكم في تركيا الاشتباك مع عقيدة الدولة التركية هذه، بل قدّم نفسه منذ البداية – للداخل والخارج – على أنه حزب خدماتي محافظ لكن غير مؤدلج، متناغم مع الهوية العلمانية الكمالية للدولة، خطته النهوض بالاقتصاد التركي وتقديم الخدمات للمواطن. وبذلك – فيما يبدو – تجنب الحزب الحاكم على مدى سنوات طويلة خطر الانقلاب عليه كما حصل مع أحزاب الإسلام السياسي ممثلة في “الميللي غوروش” (تيار الفكر الوطني) التي خرج من تحت عباءتها.
بيد أن الإصلاحات الاقتصادية أمنت للعدالة والتنمية بقيادة اردوغان حاضنة شعبية قياسية بالمقارنة مع الأحزاب سالفة الذكر. من جهة أخرى، استفادت الحكومات المتعاقبة من ملف عضوية الاتحاد الأوروبي للقيام بسلسلة من الإصلاحات الديمقراطية في بنية الدولة وفصل عمل المؤسسات ساهمت في تحجيم دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية التركية. صحيح أن ذلك أدى فيما يبدو إلى غضب الأخيرة ومحاولة بعض عناصرها التخطيط لانقلابات (تستمر التحقيقات والمحاكمات في قضايا أرغنكون والطرقة ولم يثبت شيء بعد) إضافة إلى دعوى إغلاق الحزب عام 2007، إلا أن الأخير تخطى كل هذه العوائق ويبدو الآن ممسكاً بتحكم أفضل بدفة المشهد السياسي في البلاد.
معارك الهوية المتدرجة
حين تصدر حزب العدالة والتنمية الانتخابات البرلمانية للمرة الثالثة عام 2011 قال اردوغان إن الحكومة الأولى كانت تعتبر فترة المبتدئ أو “الصّبي” والثانية فترة “العامل” أما الثالثة ففترة الأستاذ أو “الأوسطى”، كناية عن الاحتراف في العمل الحكومي، والتخطيط لرؤية وأهداف “تركيا الجديدة” أو تركيا الكبيرة التي يبشر الحزب الحاكم بها، على مشارف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية (2023).
وفي صلب هذه الرؤية المؤسسة لجمهورية تركية جديدة (يحلو للكثيرين تسميتها بالجمهورية الثانية) على مبادئ مختلفة تلوح بعض التفاصيل التي تحمل رمزية ما، فتثير جدلاً واسعاً وهجوماًُ على الحزب الحاكم، ذاك الذي امتدح لسنوات طويلة بسبب حكمته وتفويته فرص الجدل الأيديولوجي واهتمامه بالمضمون أكثر من المظاهر وتركيزه على التوافق الوطني والابتعاد عن المشاحنات.
يعتبر الكثيرون هذه التفاصيل معارك جانبية لا فائدة ترجى منها، بينما يرى البعض أن اردوغان يتعمد إثارتها للبقاء في دائرة الضوء بعد انتقاله من رئاسة الحكومة إلى رئاسة الجمهورية. لكن نظرة فاحصة عن كثب لعمل دؤوب – ولكن متأنٍ – يجري منذ سنوات، ستشير إلى ما هو أبعد وأعمق من ذلك، ما يصلح أن يسمى معركة هوية. من ذلك:
أولاً، تقليل الاحتفاء الرسمي بالأيام الوطنية، التي تصادف عادة ذكرى أحداث لها علاقة بمصطفى كمال أتاتورك (دخوله لمدن معينة أو مناسبات هو حددها)، بذرائع مختلفة مثل زلزال مدينة فان أو “مرض” الرئيس غل أو غيرها. فضلاً عن استعمال القيادات التركية وخاصة اردوغان اسم “مصطفى كمال” وحده دون لقب “أتاتورك” الذي يعني أبو الأتراك أو جد الأتراك، والدلالة هنا أكبر من أن تخفى على مراقب، ولذلك تثير المعارضة هذه المسألة بين الفينة والأخرى.
ثانياً، العمل على التغيير طويل المدى مع الأجيال الجديدة من خلال تغيير مناهج التعليم وإدخال المواد الدينية فيها (اختيارياً في الوقت الحالي)، وتعديل النظام التعليمي برمته من خلال خطة (4+4+4) التي مكنت الحكومة من التعديلات المذكورة آنفاً، إضافة لإلغاء الاحتفال “بعيد الطفولة والسيادة الوطنية” وترك الأمر “لكل مدرسة تحتفل بنفسها” بذريعة أن الاحتفالات المركزية في استادات الرياضة الكبيرة في الهواء الطلق – كما كان معتاداً – يعرض الأطفال الصغار للبرد.
ثالثاً، اللغة العثمانية التي أوصى المجلس الاستشاري لوزارة التعليم بتدريسها اختيارياً في الثانويات الحكومية، ودافع عنها الرئيس التركي منتقداً من “قطعوا الصلة بين الشعب وماضيه وثقافته وحضارته” معتبراً اللغة التركية الحالية غير قادرة على مواكبة العلوم المختلفة، حين أعطى مثالاً على فقرها وعجزها عن استيعاب علم مثل الفلسفة مثلاً.
رابعاً، تفاصيل تندرج تحت باب الرمزية الثقافية أو التاريخية المتعلقة بالهوية مثل جوقة الاستقبال المكونة من 16 جندياً في القصر الرئاسي يرمزون – بأزيائهم وأشكالهم المختلفة – للدول التركية الستة عشر عبر التاريخ، وانتقال اردوغان إلى قصر رئاسي جديد غير ذاك الذي اعتاد الرؤساء منذ أتاتورك بالإقامة فيه، وصولاً إلى تغيير اسم الاجتماعات التي اعتاد الرؤساء على تنظيمها مع مختلف أطياف المجتمع من ولائم “الكوشك” (الاسم الاصطلاحي للقصر الجمهوري منذ عهد أتاتورك) إلى ولائم “القصر الرئاسي”، وأخيراً عدم تعليق صورة “مصطفى كمال” على جدار القصر الرئاسي في أحد الاجتماعات بذريعة أن أعمال الصيانة فيه لم تنته بعد (!).
بيد أنه لا يمكن توقع “حرب” يخوضها العدالة والتنمية على أتاتورك، لا اسماً ولا تاريخاً ولا إنجازات، بل كل ما هنالك أنهم يسعون إلى “نزع هالة القداسة” عن الرجل وميراثه، وربما يؤكد هذا التحليلَ إعادةُ تعليق الصورة في الاجتماع الوزاري الذي ترأسه اردوغان في قصره، إضافة إلى تضمين الأخير “مصطفى كمال” في خطاباته لدى الحديث عن رجال السياسة التركية العظام، إلى جانب السلطانين محمد الفاتح وعبدالحميد الثاني من العهد العثماني، ومندريس وأوزال وأربكان من المعاصرين.
والحال كذلك، يمكن القول بأريحية إن اردوغان وداود أوغلو وأصدقاءهما يخوضون معركة هوية، لكن متأنية ومتدرجة وسلمية، بنفس الطريقة التي خاضوا فيها معارك تركيا الأخرى، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وهو ما ينم عن فهم لطبيعة التغيرات الاجتماعية والثقافية والفكرية التي تحتاج لاستراتيجية واضحة بعيدة المدى وطويلة النفس، الأمر الذي نلمح الكثير من تفاصيله في رؤى العدالة والتنمية لأعوام 2023 ثم 2076، ونرى بين طياته ثقة في النفس واستراتيجية في التفكير والتخطيط.